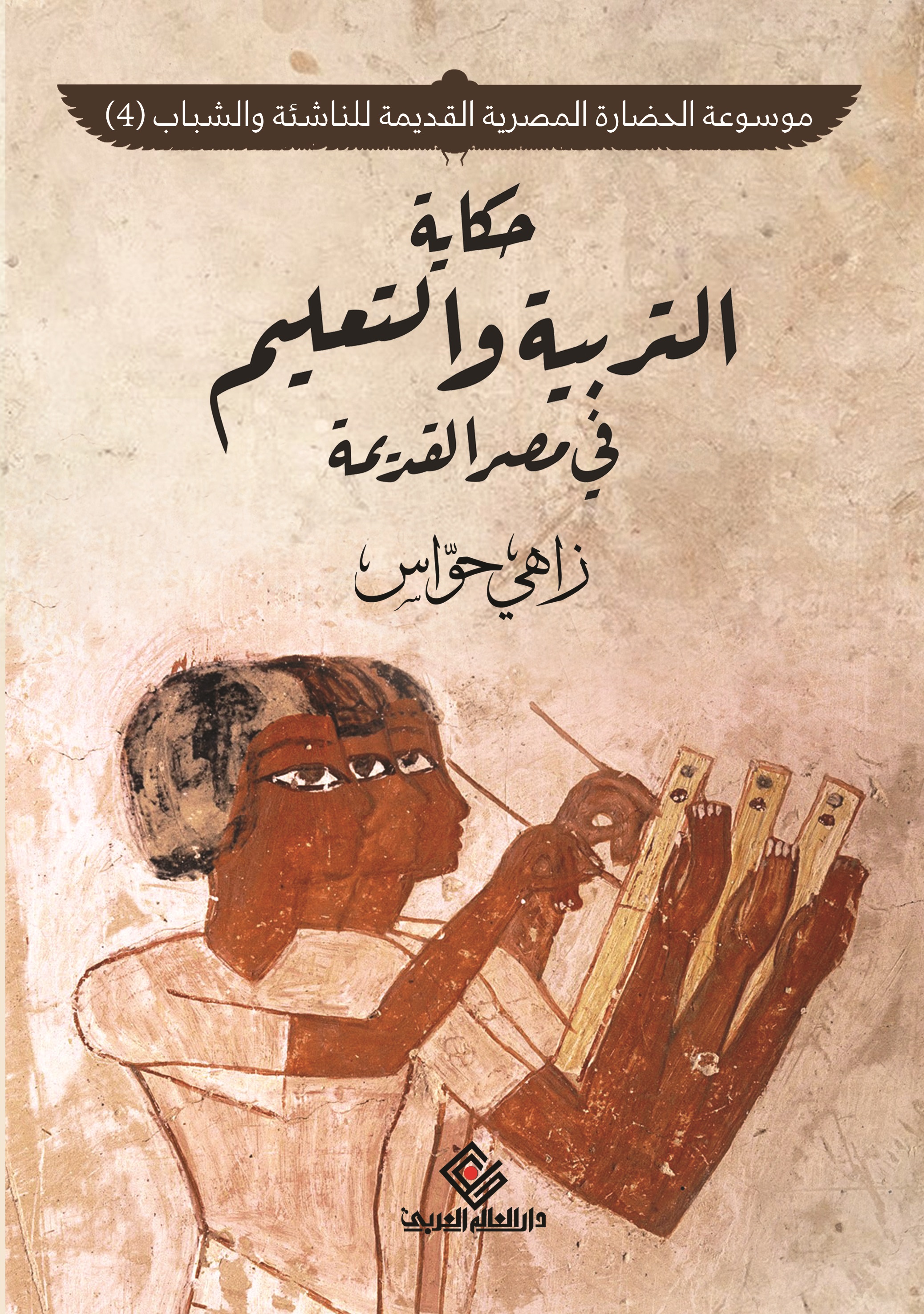
كانت حياة المصري القديم بسيطة للغاية، لكنها قامت على أنظمة محددة وثابتة؛ فقد اهتم المصريون القدماء بالتعليم، وكانوا يقدّرونه تقديرًا كبيرًا؛ لما يحققه من تفوق في شؤون الحياة، فاعتبروه الحدَّ المميِّز بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة.. ولذا كان للتربية والتعليم مكانة كبيرة في مصر القديمة؛ إذ كانتا من الأشياء المهمة التي تساعد على الترقي في الوظائف المختلفة.
كان الأب هو المسئول عن تربية وتعليم ابنه، وكان يكتب ذلك في تعاليم، وهي عبارة عن نصائح يوجه فيها الأب خلاصة تجاربه لابنه. ومن أشهر هذه التعاليم: تعاليم «بتاح حتب»، والتي ظلت تُدرس للتلاميذ طوال العصور الفرعونية.
وقد كان التعليم مقتصرًا على فئة معينة، فمعظم الأطفال المصريين لم يذهبوا إلى المدرسة، ومَن يذهب منهم يصبح كاتبًا، ليبدأ بذلك أول درجة في سلم الوظيفة، ثم يأخذ في التدرج بمناصب الدولة. وكان يُعفى من جميع الأعمال البدنية والمتاعب الشاقة. ومع الأسف، كانت الفتيات لا يتعلمن. وقد كان الكَتَبَة هم الذين يقومون بالتعليم. وكان تعليم الطفل يبدأ من سن خمس سنوات إلى تسع سنين، ويستغرق وقت الدراسة نصف يوم، يجري فيه تعلُّم وإتقان أسرار الكتابة. وكانوا يدرسون بجدية ودأب، وكان كل من يتهاون في الدراسة يعاقَب.
كانوا يتعلمون في مكانٍ عُرف عند المصري القديم بـ«بر عنخ»؛ أي بيت الحياة.. فكان الطالب يتلقى فيه كل علوم الحياة.. وهو يشبه الجامعات والمكتبات في عصرنا الحالي.
وقبل أن يصل الطالب إلى الـ«بر عنخ»، كان يمر منذ طفولته بمراحل أخرى، تبدأ بدراسة بسيطة يتعلم فيها مبادئ القراءة والكتابة في مكان يشبه الكتاتيب، ثم ينتقل بعدها إلى مرحلة دراسية أعلى يلتحق بها المتميزون من التلاميذ. وكانت بيوت الحياة تخدم نواحي متعددة من مجالات الحياة في مصر القديمة، من أهمها: الحياة الدينية، وما تحمله من طقوس ومعتقدات، فكانت تُكتب فيها البرديات التي تحكي عن احتفالات الآلهة وأعيادها. وكان من أهم الأعمال التي تؤدَّى في دُوْر الحياة تلك:
تأليف الأناشيد الخاصة بالملوك، ونَسْخها وتوزيعها على مختلف المعابد في أرجاء البلاد المختلفة.
وقد عرف المصري القديم صناعة الورق من نبات البردي واستخدامه في الكتابة منذ عصر الأسرة الأولى، حيث عُثر عليه في مقبرة «حماكا». وكان ورق البردي يُصنع من سيقان النبات التي كانت تُقَطَّع أولًا إلى شرائح رفيعة بشكل رأسي، ثم تُرَصُّ أفقيًّا ورأسيًّا، ثم تُضْغَط حتى تلتصق ببعضها مكونةً ورقةً، كان المصري يكتب ويسجل عليها كل الأشياء المهمة.
وكان وجه الورقة ـ الذي يُعرف حاليًّا باسم Recto ـ هو الذي تكون الألياف فيه أفقية، وهو الذي يُبدأ في الكتابة عليه أولًا. كما كان يُكتب أيضًا على ظهر الورقة ـ والتى تُعرف لدينا الآن باسم Verso ـ وتكون الألياف فيها رأسية. وكانت أطراف الورق تلصق ببعضها عن طريق وصلات تُعرف باسم Joint، فتتكون من ذلك لُفَافَةُ برديٍّ طويلة. وكانت الكتابة على أوراق البردي أفقية في البداية، ولكن منذ عصر الأسرة الثانية عشرة، أصبحت الكتابة عليها في سطور رأسية أيضًا. وكانت الكتابة تدوَّن عادةً بالمِدَاد الأسود، أما بدايات الجُمَل والعناوين فكانت تدوَّن باللون الأحمر فيما يُعرف حاليًّا باسم Rubric.
وقد كان ورق البردي مادةً نفيسةً جدًّا وقتَ ذاكَ، حتى إنه لم يكن يوزَّع على المبتدئين في الكتابة، ولم يَنْسَخ عليه إلا الكَتَبَة وبعض التلاميذ في المراحل المتقدمة من تعليمهم، بعد أن يؤدوا تمارين عديدة في الكتابة عليه.
أطلق عليه الإغريق اسم "الهيروغليفي Hieroglyphic"، ويعني: النقش المقدس؛ وذلك لنقشه على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات والمسلات والأعمدة، وكذلك لنقشه على تماثيل الآلهة والملوك والأفراد.
وقد مرت الكتابة الهيروغليفية بتطورات عديدة؛ إذ اعتمدت في البداية على تصوير كل ما يمكن نقله وفهمه من الطبيعة، من إنسان وحيوان ونبات وطير وجماد، ثم لجأت بعد ذلك إلى العلامات الصوتية لتحديد ما لا يمكن تصويره من أحاسيس وأفكار ومشاعر. فالكتابة المصرية هي كتابة تصويرية، ولكل صورة علامة صوتية، الغرض منها تحديد النطق الخاص بهذه الصورة.. فهناك علامات تصويرية ذات صوت واحد، والتي تُعرف اصطلاحًا بـ"أبجدية اللغة المصرية القديمة"، وتتكون من 24 رمزًا.. وهناك علامات ذات صوتيْن، وعلامات أخرى ذات ثلاثة أصوات.
تَطَوَّرَ الخط الهيروغليفي إلى نوعٍ مبسَّطٍ آخَرَ من الخط، أطلق عليه الإغريق اسم "الخط الهيراطيقي Hieratic"؛ أي الخط الكهنوتي، إشارةً إلى أن الكهنة كانوا أكثر الناس استخدامًا لهذا الخط، وذلك بعد أن تَعَذَّرَ عليهم استخدام الخط الهيروغليفي في شؤونهم العامة. وقد اقتصر استعمال هذا الخط على الكهنة في العصور المصرية المتأخرة. ولقد كُتب به على أوراق البردي، وعلى قِطَع الفَخار (الأوستراكا)، وكذلك على الخشب.
هو شكل سريع مختصر للهيراطيقية، أطلق عليه الإغريق اسم "الخط الديموطيقي Demotic"؛ أي الخط الشعبي. ولا يعني هذا المسمَّى الربط بين هذا الخط والطبقة الشعبية في مصر، فإنما هو خط المعاملات اليومية. وقد جاء ابتكار هذا الخط نتيجة لتعدُّد الأنشطة وكثرة المعاملات، وخاصة الإدارية منها، والتي تحتاج عادةً إلى سرعة في الإنجاز.
استُعمل هذا الخط في جميع نواحي الحياة العامة، وذلك ابتداءً من عهد الأسرة الخامسة والعشرين حتى نهاية حكم الرومان لمصر. وقد كُتب بهذا الخط على مادتيْن أساسيتيْن، هما: البردي، والأوستراكا (الشُّقَافَة الفَخَّارية).
إن كلمة «قبطي Coptic» مشتقة من الكلمة اليونانية «أيجوبتي Aiguptos»، وتعني «مصري»؛ إشارةً إلى المُواطِن الذي عاش على أرض مصر، وإلى الكتابة التي عبَّرت عن لغته في هذه المرحلة. ويتضح من هذا أن كلمة «قبطي» تعني في الأصل «مصري»، وإنْ كانت تطلَق الآن بشكل خاص على إخواننا المسيحيين من أبناء مصر.
يمثل هذا الخط المرحلة الأخيرة من مراحل اللغة المصرية القديمة. وهو مكتوب بحروف يونانية، مضاف إليها سبعة أحرف مأخوذة من الديموطيقية؛ لأن هذه الأحرف السبعة لا مقابل لها من الناحية الصوتية في اللغة اليونانية.
وربما يرجع السبب في أن يكتب المصري القديم خلال هذه المرحلة التاريخية بحروف يونانية، إلى اضطراره ـ لأسباب عملية تتمثل في وجود اليونانيين الغزاة في مصر ـ إلى أن يبحث عن خط يسهِّل له وسيلة التفاهم معهم، فاختار الأبجدية اليونانية لكى تعبّر عن أصوات اللغة المصرية؛ وذلك حفاظًا على لغته الأصلية.
وقد تعددت لهجات اللغة القبطية من صعيدية إلى بحيرية وفيومية وأخميمية، وظلت مستخدمةً حتى بعد دخول الإسلام مصر.. ولا تزال القبطية في إحدى لهجاتها مستخدمةً في الصلوات بكنائسنا المصرية حتى يومنا هذا.
ساعد على تطور الكتابة أيضًا ونشر الثقافة، اختراع المصري القديم للأقلام والأحبار والأصباغ.
وقد استُخدم المداد الأسود والأحمر في الكتابة. وكان اللون الأسود يُستخرج من ثلاثة مصادر: السِّنَاج (الهِبَاب) الذي يتكون من حرق الوقود أسفل القُدُور والأواني، وكان يُكْشَطُ أولًا من أوعية الطبخ، ثم يُمزج ـ بعد أن يتم طحنه جيدًا ـ بمحلولٍ سائل من الصمغ العربي المجفف. كما استُخرج من تفحيم خشب السَّنْط، وكذلك من معدن المنجنيز. ومن أقدم الأمثلة على استخدام المِدَاد الأسود: ما وُجِدَ منه مخطوطًا على بعض الأواني الفخارية في عصور ما قبل الأسرات.
أما اللون الأحمر للمداد فكان يُستخرج من مادة "المُغْرَة الحمراء"، وهي كثيرة في الصحراء، أو من مادة خام الحديد. وكلا النوعيْن كان يعد في شكل أقراص صغيرة، تجفَّف أولًا، ثم تُدَقُّ وتُذاب في الماء، ثم توضع في الدَّوَاة عند الاستعمال.
وكانت فرشاة الكتابة تُصنع من نبات "السُّمَّار المُرّ" الذي ينمو طبيعيًّا على ضفاف البِرَك والمستنقعات، وكذلك في الأراضي الشاطئية المِلْحَة.
وكانت أطوال أقلام الكتابة تتراوح ما بين 16 إلى 23 سم. وكان أحد طرفي ساق النبات يُبرَى بمَيْل ليأخذ شكل رأس الإزميل، ثم تُفصل ألياف هذا الطرف بمضغها بالأسنان لتعطينا فرشاة دقيقة يمكن الكتابة بها. كما استُخدمت للكتابة أيضًا أقلامٌ مصنوعة من نبات الغاب.
ولقد كان الكاتب يتنقل في أماكن مختلفة بمراكز الدولة والمعابد لكي يسجل الأشياء المهمة، فكان يضع أدوات الكتابة في "مَقْلَمَة"، وكانت الدواة والمقلمة تُصنعان معًا في أداة واحدة من الخشب أو العاج، وكان بها عينان للمِدَاد، إحداهما للأسود والأخرى للأحمر، إضافةً إلى صندوق صغير مستطيل لحفظ الأقلام؛ مثل مقلمة «توت عنخ آمون» المصنوعة من الخشب المغطَّى برقائق الذهب.