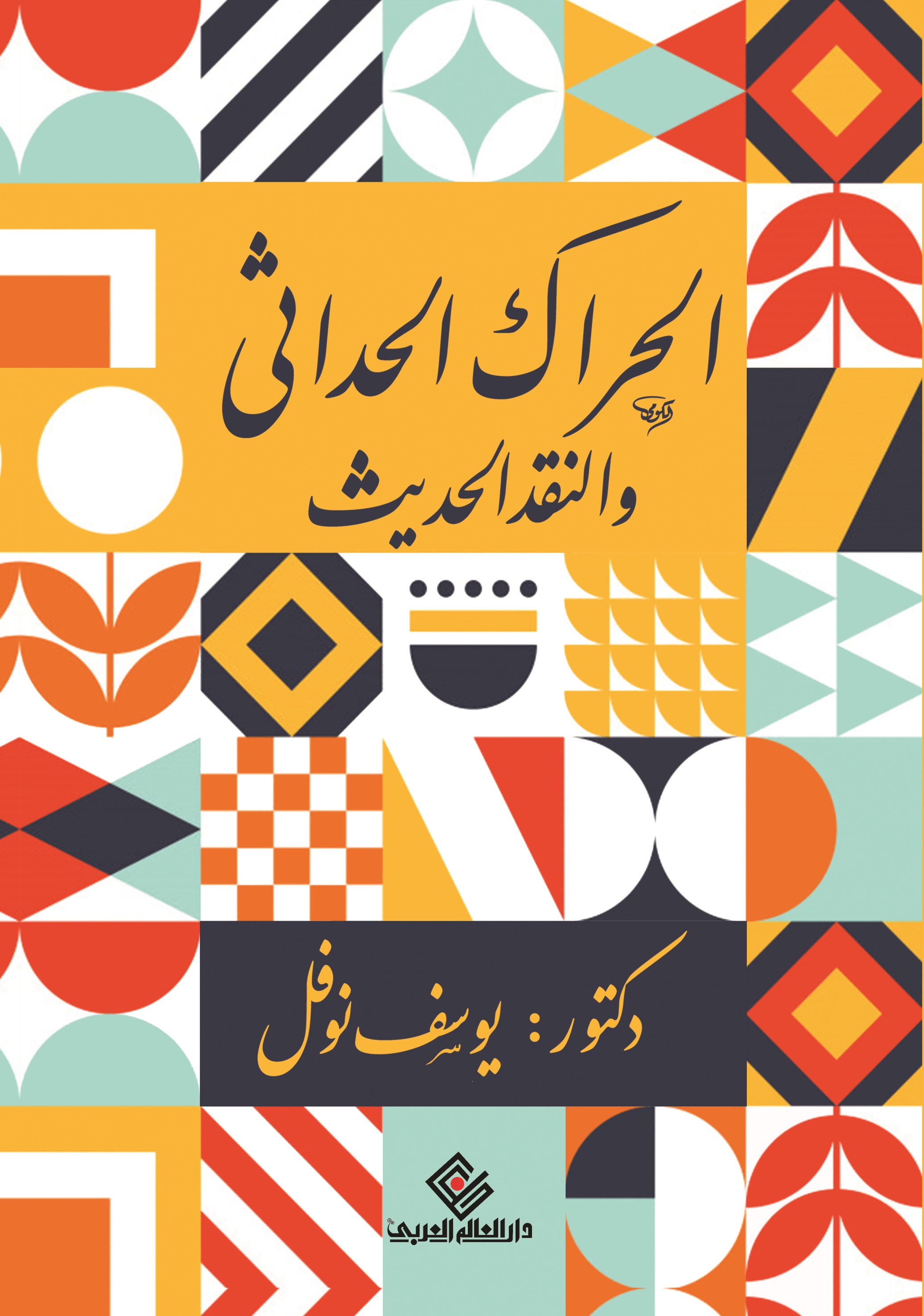
تنظيرالتحديث، والحداثة، وما بعد الحداثة، ومابعد ما بعد الحداثة.
Post ـ postmodernism ـ Modernism
من رحم القديم إلى الجديد/ حراك التراث والمعاصرة :
ينبغي التنبه إلى أن الفكْر الحداثي العربي ليس وليد اليوم، أو الأمس القريب، وليس منتسبا إلى أسماء بعينها، في عهد قريب، وليست، في ذاتها، فكرا مجلوبا مستوردا بشكل خالص مصفـّى. بل هو نتاج وحصاد ومخاض وثمار لرحلة طويلة عبْر عقود من الزمان، وأجيال من المفكرين والمبدعين، عبْرمناخات، وعصور، وعوامل، وتفاعلات سنراها، ونستحييها مرة اخرى على ألسنة أصحابها، الذين أعدّهم ـ بحق ـ آباء الحداثة العربية دون ادّعاء، أو مبالغة، أو مسخ، أو اسنتساخ،أو استيراد، أو مسْح للذاكرة، وبذلك يمـْثل التيار التجديدي تحديثا متجددا عبْر عقود الزمان، في فسيفساء تتكامل ولاتتنافر، تتواصل دون انقطاع منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، وليس غريبا أن تشهد بدايات القرون ومطالعها الطلائع والبواكير، فقد شهدتْ ميلاد النظريات والمخترعات، ومنها، على سبيل المثال: البطارية الكهربائية لفولتا الإيطالي 1800، ونظرية الأرقام 1801، وقانون تمدد الغازات 1802، والمورفين 1806، ونقل الدم 1905، والفيتامينات 1906، والنسبية لأينشتين 1905، والمصباح الكهربائي 1911....
كما شهدت ميلاد أعلام التغيير عندنا وفي العالم، ومنهم، على سبيل المثال: الطهطاوي 1801، والشدياق 1804، واليازجي 1800، والشابي 1906، وكورني 1606، وملتون 1608، وفيكتور هوجو 1802، وسارتر 1905.....ليكونوا مجددين، قبل أن تأتي عقود من الزمان، أو قرن جديد بمستحدث يجعل جديدهم قديما.
وربما صدقتْ مقولة ابن قتيبة، في حينها، " جعل الله كل قديم حديثا في عصره"، الشعر والشعراء1/10، و11، وقول المأمون : " أحسن الكلام ما شاكل الزمان"، وقول ابن خلدون : " إن أحوال العالم لا تدوم على وتيرة واحدة ومناهج مستقرة"، و عندما أشار السيوطي في كتابه التنبيه بمن يبعثه الله على رأس كل مئة بنى نظرته على أن المحن على رأس القرون، متوجسا من كل جديد مفاجئ داهم. أما أمين الخولي فرأى أن التجديد الجذري في رؤوس القرون هو العمل الثوري الكبير الذي تحتاج الأمة إليه، كأنما هو" ثورة اجتماعية دورية"، المجددون في الإسلام 1993، ص17.
وفي النقد العربي القديم أطلق النقاد لقب المحْدثين على منْ جددوا من المخضرمين، الذين بدأ عهد المحْدثين بهم من أمثال: بشار بن برد، ومروان بن بي حفصة، ومطيع بن إياس، ومن تلاهم وقد ظلت كلمة " التجديد " هاجسا فنيا يخامر أفئدة الدراسين والنقاد والباحثين وزعماء الإصلاح والمبدعين، لا يغيب عنهم في كل زمان وكل مكان، وتمثّل في ثنائية القديم والجديد في شكْـل: حوار أو صراع، أوفي شكل التراث والمعاصرة، أوفي شكل الجمود والتطور، الثبات والتحرك، تفاعلتْ تلك التيارات والجماعات والمدارس ، حتى تراوحتْ مواقف بعضها بين روح العدوانية، أوحرارة الخصومة، أوحدّة المعارك. بل بالغ البعض حتى كان على شفا الوسم بالإرهاب، أوالهجاء، والنيْـل من الآخر، وبدا ذلك في عنوانات مثل: روح العصر ـ الثورة ـ الإصلاح ـ التطور ـ الأصالة والتحديث ـ أو الأصولية والحداثة ـ القديم والجديد ـ الحداثة ـ الحريةـ الرفض ـ التمرد....وكانت لهجة النقد في عنوانات حادة، أحيانا، من مثل: على السفود، على المحك، في الميزان، صنم الألاعيب...
كان ذلك في إطاره العالمي المؤمن بفلسفة التقدم والتطور، في مواجهة بين الفلسفة التقليدية التراثية والموقف الوضعي، وجموحات الخيال العلمي فيما كتبه" جول فرن " الذي لقب بنبي القرن العشرين، والذي ألهم المخترعين والمكتشفين في الجو والبر والبحر بما ابتكر من روايات الخيال العلمي، ومضى ذلك، أيضا، في فلسفة التاريخ الجدلي لدى هيجل، ونظريات داروين، ونسبية آينشتين، ونظريات ماركس وإنجلز المادية في تفسير التاريخ، وأعمال شاتوبريان، وجوته، وهوجو، وبودلير، وموسيقى وأوبرات فاجنر، وفيردي، وبرليوز، وبرامز، وتشايكوفسكي، وتصوير تورنر، ودي لاكوروا، وكتابات مانزوني، ومويد بنورج وبسن، وتولوستوي، ثم تشيكوف، وتأثير تجربة محمد علي بمصر في تجربة، أو ثورة " ميجي" إمبراطور اليابان الإصلاحية عام 1867، وتطور الأمور في دوائر الحروب والغزوات إلى تنافس قطبين عالميين، ثم هيمنة القطب الأوحد، والتوجه إلى استفحال سيطرته في النظام العالمي الجديد، وفي إطار هيئة الأمم المتحدة شهدتْ الأعوام 1978 ـ 1982 مشروع " البدائل الاجتماعية ـ الثقاقية للتنمية في عالم متغير"، ومن فروعها " تغيير العالم"، على نحو ما فصّل متخصص كبير هو أنور عبد الملك في كتابه تغيير العالم، عالم المعرفة95، الكويت نوفمبر 1985 ، في أبوابه: عالمية العالم، وقنوات التغيير، والتحديات والرؤى في 265 صفحة، وما تبع ذلك من مثاقفة، أو تثاقف بالتأقلم الاجتماعي الثقافي اللغوي،كما فصّل عبد السلام المسدّي في كتابه مفاهيم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته، الجزائر/تونس 1991.
وفي الشاطئ المقابل من النهر، أو من العالم كان الشرق الحضاري يحاول المواءمة بين طوفان التوغل والغزو الغربيين، والتعامل معهما بشكل يحافظ على الخصوصية الشرقية حضاريا ووطنيا، حيث ظهرت تلك العنوانات سالفة الذكْر، وذلك منذ الانبهار بحملة الغزو الفرنسية البونابرتية، لمدة ثلاث سنوات( 1798ـ1801)، التي أشبهتْ العاصفة التي هبـّتْ فأيقظتْ ونبـّهتْ وأطْلعتـْنا على طاقات نور خارج عالمنا المغلق، بما صحب الحملة من علماء عددهم: 146 عالما، أسسوا في الثاني والعشرين من أغسطس سنة 1798 المجمع العلمي المصري(الذي أشْرف بعضويته) على غرار المجمع العلمي في باريس، وشعاره: التقدم والاتحاد، وبدأتْ اجتماعاته الأولى في دار حسن بك كاشف بالناصرية، وما استحضرتْه الحملة من منجزات عصرية حديثة، وإضافات في حقول: المكتبة، والمطبعة، والصحافة، وما كان لذلك من تأثير فكري أطال الحديث عنها الباحثون، ومنهم ما كتبه محمد أمين حسونة سنة 1951 بمجلة الالكتاب، مارس، ج3، س6، مج10ص219،ومنذ ظهور محمد علي وانتصاراته وفتوحاته، فنتج عن ذلك كله تعدد المواقف الفكرية والفلسفية، فنشطت الآراء خلال القرن التاسع عشر، وأوائل الربع الأول من القرن العشرين، حتى تفاعلت المواقف المتباينة